الترجمة
1- تعريف التّرجمة :
إنّ كلّ تعريف للتّرجمة معرّض للطّعن مهما كانت بساطته ومهما كان تعقيده، بل إنّ الإشكال الأكبروالمبحث الأهمّ في الترجمة يتعلّق ، في الحقيقية ، بتعريفها الذي لا يمكن أن يكون موضوعيّا لا ينحاز إلى نظريّة على حساب نظريّة أخرى أو لا يطرح روية جزئيّة. بل يمكن أن نحاكي ما قاله ابن خلدون في الأدب بالقول إنّ التّرجمة علم لا مادّة له. فالتّرجمة تقوم على اللّغة في البدء وفي المنتهى .وكلّ ما يتعلّق باللّغة متعلّق بها .واللّغة تحوي كلّ شيء. فالتّعريف السّاذَج للتّرجمة باعتبارها «عمليّة تحويل الكلام من لسان إلى آخر ، مع المحافظة على المحتوى دون الحرف» لا يثبت أمام واقع التّرجمة بمستوياتها وبخاصّة ترجمة النّصوص المقدّسة. فلو كان الأمر كذلك لما تحدّث الباحثون عن «ترجمة معاني القرآن»، إذ سيكون مثل هذا التّصنيف إمّا حشوا أو مفارقة. وفي الماضي، كان ينظر القدامى إلى التّرجمة نظرة نفعيّة قد تنحدر إلى السّلبيّة ، لاعتبارهم العمل التّرجميّ مجرّد نقل آليّ لكلمات من لغة إلى أخرى لا يرتقي إلى درجة العمل الفكريّ. وفي تلك النّظرة اختزال لعمليّة التّرجمة في شرط الازدواجيّة اللّغويّة .وهو شرط ضروريّ . لكنّه ليس كافيا ولا يمكن أن يكون. ولم تتحسّن النّظرة إلى التّرجمة مع مرور الزّمن ولا مع تطوّر التّقعيد والتّنظير ، إذ التصقت بالمترجم صفة الخائن: «كلّ ترجمان خائن خوّان» (traduttore traditore). واعتمادا على هذا الفهم نشأت تلك النّظرة السّلبيّة إلى المترجمين والتّرجمة. وقد يكون من أسبابها تلك الشّروط المجحفة التّي يدفع بها الجاحظ (كتاب الحيوان) فيجعل عمل التّرجمة شبه مستحيل: «ولا بدَّ للتَّرجُمانَ من أن يكون بيانهُ في نفس الترجمة، في وزْن علمه في نفسِ المعرفة، وينبغي أن يكون أعلمَ الناس باللّغة المنقولة والمنقولِ إليها، حتَّى يكون فيهمِا سواءً وغاية، ومتى وجدناه أيضاً قد تكلّم بلسانين، علمنا أنَّه قد أدخلَ الضيمَ عليهما، لأنَّ كل واحدةٍ من اللّغتين تجذب الأخرى وتأخذُ منها، وتعترضُ عليها، وكيف يكونُ تمكُّنُ اللّسان منهما مجتمعين فيه، كتمكُّنِه إذا انفرد بالواحدة، وإنَّما له قوَّةٌ واحدة، فَإنْ تكلّمَ بلغةٍ واحدة استُفْرِغَتْ تلك القوَّةُ عليهما، وكذلك إنْ تكلَّم بأكثرَ مِنْ لغتين، وعلى حساب ذلك تكون الترجمةُ لجميع اللغات، وكلَّما كانَ البابُ من العلم أعسرَ وأضيق، والعلماءُ به أقلَّ، كان أشدَّ على المترجِم، وأجدرَ أن يخطئ فيه، ولن تجد البتَّةَ مترجماً يفِي بواحدٍ من هؤلاء العلماء». ورغم تراكم التّرجمات وتعدّد النّظريّات التّي ترى في التّرجمة عملا يتجاوز نقل المحتوى من لغة إلى أخرى وتقويم التّرجمات بحسب مستوياتها ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها واعتبارا لحتميّة اختلاف الأنظمة السّيميائيّة التّي تقوم عليها ، فإنّ الكثيرين من المتشبّثين برؤية الجاحظ ما زالوا يرون في التّرجمة خيانة و في التّرجمة الصّائبة عمليّة مستحيلة. ويبدو أنّ مردّ عقدة الذّنب التّي تولّدت عند المترجمين وضع الأصل الذي يُترجم منه موضع القدسيّة والإصرار على ألاّ تكون التّرجمة إلاّ نسخة رديئة منه.
2- تاريخ التّرجمة :
يمكن أن يؤرّخ لأوّل عمل في التّرجمة باعتباره أوّل شاهد على تماسّ اللّغات والثّقافات عرفته حضارة ما بين النّهرين في شكل معجم مزدوج اللّغة سومريّ- أكاديّ .وهو عبارة عن جدول ذي خانتين تتقابل فيهما الكلمات في اللّغتين وبطريقتي كتابتها. واحتفظت مكتبات اللّوحات الطّينيّة بوثائق لا تحصى لمراسلات مكتوبة بلغات مختلفة (تلّ العمارنة، أنموذجا) تخبر بوجود نشاط ترجميّ مكثّف بين مصر القديمة وبلاد الرّافدين كان يمدّ جسرا للتّواصل بين الثّقافات والحضارات منذ أقدم العصور. أمّا العرب الذين لم يختلطوا بالأمم الأخرى إلاّ عرضا في أزمنة الجاهليّة فقد عرفوا الوضعيّة نفسها التّي كانت سائدة زمن الأكاديّين والبابليّين من اختلاط لغويّ وثقافيّ بعد اتّساع رقعة الدّولة الإسلاميّة .وقد فرض عليهم التّعامل معها بالأخذ أو بالتّواصل. وقد دفعهم حبّ الاطلاع على الثّقافات الأخرى والحاجة إلى علوم الآخرين من الفرس والرّوم إلى ترجمة أمّهات المؤلّفات وبخاصّة في ميادين كانت الحاجة ملحّة إليها. وقد بدأت عمليّات التّعريب منذ استقرار الدّولة الأمويّة .وبلغت أوجها مع العبّاسيّين (هارون الرّشيد والمأمون) بإنشاء «بيت الحكمة». وكما كانت الحاجة متعدّدة (إدارة شؤون الدولة وعلوم الهندسة والجبر والطبّ وتقانات الزّراعة) كانت اللّغات كذلك متعدّدة . فنقل من الفارسيّة والهنديّة والقبطيّة واليونانيّة، مباشرة أو بوساطة السّريانيّة أحيانا. واشتهر مترجمون أضحوا أقطابا في التّرجمة من أمثال حنين بن إسحاق وأبي يحيى البطريق ويوحنّا بن ماسويه ويحيى بن خالد ومحمّد بن جهم البرمكيّ وغيرهم. واشتهرت بعض العائلات التّي تواصل عطاؤها في ميدان التّرجمة جيلا بعد جيل كعائلة جبريل بن بختيشوع وعائلة موسى بن شاكر وعائلة الفضل بن نوبخت وعائلة الفضل بن سهل... وقد تطوّرت أساليب التّرجمة مع الزّمن .وتخلّى المترجمون عن طريقة نقل الكلمات كلمة بعد أخرى من اللّغة المنقول عنها .بل أصبحوا يترجمون المعاني فيقرأون الجملة لتمثّلها ثمّ يعرّبونها حسب ما حصل عندهم من الفهم. وهكذا كان يفعل حنين بن إسحاق خلافا لسابقيه من المترجمين. ولا يهمّنا هذا التميّيز من باب تأريخ التّطوّر بقدر ما يهمّنا من منطلق ربط التّطبيق بالنّظريّة ونسبيّة تعريف التّرجمة. ففي اختلاف طريقتي التّرجمة اختلاف في تعريفها اعتمادا على مادّتها التّي تتحوّل من ترجمة الألفاظ إلى ترجمة المعاني. ونرى كيف أنّ هذه النّظرة قد تطوّرت مرّة أخرى في مرحلة لاحقة فأحدثت منعرجا حاسما في تاريخ التّرجمة .ونعني بها بداية القرن التّاسع عشر الرّومنسيّ . وفي هذا الصّدد ينقل هومبولدت (W. von Humboldt) موضوع التّرجمة من الألفاظ ومعانيها إلى النصّ وتأويله .فيقول: «الكلمات المترجمة تكذب دائما .أمّا النّصّ المترجم فلا يكذب إلاّ إذا كان سيّئ التّرجمة» (عن هرالد فاينريش، لسانيات التمويه ص 24، [ Weinrich (Harald), Linguistik der Lüge, C.H. Beck Verlag, München 2000.]).
3- التّرجمة وعصر النّهضة:
بعد الصّدمة التّي أحدثتها حملة نابوليون على مصر واستفاقة العرب على وقع تخلّفهم المزري مقارنة بنهضة الغرب وتقدّمهم العلميّ والتّقنيّ عاد الوعي بضرورة التّرجمة وأهميّتها لتحقيق التّقدّم الحضاريّ واكتساب أسباب العلم والتّكنولوجيا. رأى محمّد علي باشا (1805-1849) في التّرجمة جسرا لا بدّ من عبوره لنقل العلوم من الحضارات التّي تقدّمت فيه أشواطا (وهي في واقعه الحضارات الغربيّة والفرنسيّة على وجه الخصوص) نحو الحضارات الرّاغبة في الالتحاق بها ، كما هي جسر لا بديل عنه أيضا للتّواصل الفكريّ والتّبادل الثّقافيّ والإبداعيّ بين الحضارات. وبعد صدمة الفجوة التّكنولوجيّة التّي اكتشفها العرب في أنفسهم، بادر محمّد علي باشا مؤسّس مصر الحديثة إلى اتّباع الطّريق التّي سلكها أسلافه من العبّاسيّين ويسلكها كلّ راغب في اكتساب العلوم والتّقانات من الأمم التّي سبقته فيها (وهو ما فعلته اليابان ثمّ قام به الاتّحاد السّوفييتي في بداية القرن العشرين وما تفعله الصّين اليوم). فسعى بعزم ومثابرة إلى توطيد حركة التّرجمة في البلاد المصريّة. فأرسل البعثات الواحدة تلو الأخرى إلى باريس .وألحّ عليها إلى حدّ التعسّف لترجمة ما تحتاجه البلاد من كتب ومؤلّفات علميّة .وأسّس «مدرسة اللّغات» سنة 1835. ووضع على رأسها رافع رفاعة الطّهطاويّ ( 1801 - 1873 صاحب تخليص الإبريز في تلخيص باريس الذي يعدّ أحد أكبر رموز النّهضة والتّرجمة في العالم العربيّ. وكان يرمي من وراء إنشاء «مدرسة اللّغات» التي أصبحت في ما بعد «مدرسة الألسن» إلى تكوين الكفايات اللاّزمة في الّلغات الأوروبيّة التّي تغنيه عن إرسال البعثات المُكْلِفة. وقد عرفت تونس المسار نفسه تقريبا . فترجمت الكتب العلميّة المتعلّقة بفنون الحرب، إذ سلك المشير أحمد باي السّياسة نفسها التّي اتّبعها محمّد على في مصر .فأسّس المدرسة الحربيّة بباردو سنة 1840. وكان ذلك حافزا قويّا على التّرجمة .فعرّب ما يضاهي الخمسين كتابا في الفترة الفاصلة بين تأسيس المدرسة الحربيّة وانتصاب الحماية الفرنسيّة على تونس سنة 1881. ولم تكن لتقوم للتّرجمة قائمة لو لم يسندها القرار السّياسيّ والرّغبة الصّادقة في الأخذ بناصية العلوم، إذ يتوّقف ازدهار التّرجمة أو كسادها على السّياسات اللّغويّة المتّبعة في الدّول المعنيّة. فقد مرّت بعض الأقطار العربيّة (مصر، نموذجا) بفترات كان القرار السياسيّ فيها والسعي إلى الرفع من شأن العربيّة وحظّها من و العلوم يدفعان بالتّرجمة دفعا ويبلغان بها أرقى مراتب الازدهار والتّطوّر. ثمّ حين تغيّرت تلك السّياسات وتقلّص الدعم الماديّ والمعنويّ هبطت الترجمة إلى أدنى مستوياتها. وهكذا قد عانت التّرجمة من تضارب المواقف من اللّغة العربيّة وعلاقتها بالّلغات الأجنبيّة، إذ ثمّة من يعتبر أنّ تعليم العلوم لا بدّ أن يكون بلغة العلوم وثمّة من يرى أنّ ذلك يحرم العربيّة من أن تكون لغة العلوم. وهو ما لخّصه أحمد بيرم في قوله: «إذا علّمت شخصا بلغته فقد نقلت العلم إلى تلك اللّغة أمّا إذا علّمته بلغة أخرى فإنّك لم تفعل شيئا سوى أنّك نقلتَ ذلك الشّخصَ إليها». وتحوّلت عمليّة التّرجمة بعد ذلك عن هدفها الأساس الماثل في نقل التّكنولوجيا من الغرب .واتّجهت الجهود إلى تعريب الآداب ( وقد تزامن ذلك مع الاحتلال البريطانيّ لمصر): وكان هو السّبب الذي حوّل وجهة التّرجمة من نقل التّكنولوجيا إلى نقل الفكر الغربيّ المودع في كتب الأدب .فتغلغل في الثّقافة المصريّة ومنه في بقيّة أنحاء العالم العربيّ ، خاصّة أنّ مثل تلك التّرجمة تسمّى ترجمة التَّرَف، لأنّها من الكماليّات لعدم الحاجّة الماسّة إليها باعتبارها لم يكن لها أدنى أولويّة في زمانها. وليس بوسعنا أن نؤكّد بما يكفي أهميّة طبيعة المشروع الذي تقوم عليه كلّ حركة ترجميّة مهما كان حجمها أو مدّتها. فوراء كلّ ترجمة مشروع اقتصاديّ أو سياسيّ أو ثقافيّ أو دينيّ يحرّكه ويوجّهه.ويقوم ذلك المشروع على حاجة المجتمع أو الجهة المسؤولة إلى ترجمة كتب بعينها. وكلّما كان المشروع واضحا متماسكا منتظما كانت نجاعته أشدّ. لذلك، لم تنجز أعمال التّرجمة الكبرى إلاّ لوجود مشروع يدفع نحوها. فلم تترجم كتب الّبوذيّة بآلاف صفحاتها - وقد استغرقت ترجمتها ما يزيد عن القرن - إذا لم يكن وراء ذلك حافز دينيّ قويّ ، كما أنّه ما كان للمترجمين العرب في العصر العباسيّ أن يتمتّعوا بالدعم الماديّ (وزن الكتب ذهبا) لو لم يكن خلفاء بني العبّاس يدركون أهميّة نقل العلوم. ولم يكن التّرجمة لتزدهر مثلما ازدهرت في مصر وتونس ولبنان لو لم تكن ثمّة رغبة سياسيّة صادقة تدعمها.
4- الترّجمة في عصرنا الحاضر:
4-1 : جهود تقعيد التّرجمة:
إذا استثنينا الملاحظات العَرَضيّة الفائقة الذّكاء التي أبداها الكثير من ممارسي التّرجمة قديما ومن المفكّرين في عمليّة التّرجمة والتي وردت متفرّقة فيما تٌرجم من آلاف الآثار مشرقا ومغربا فإنّنا لا نَعْدَم شظايا تنظير وبوادر تقعيد عند المترجمين اللاّتين والهنود والعرب والصّينيين في القديم وعند المترجمين الغربيّين في الفترة المعاصرة من أمثال دبلنكور (Nicolas Perrot D’Ablencourt) و شليرماخر(F. Schleiermacher) وغوته (Goethe) ونيتشه (Nietzsche)وغيرهم . على أنّ أوّل محاولة منهجيّة لتقعيد عمليّة التّرجمة قد جاءت من العلوم اللّغويّة ومن الأسلوبيّة على وجه التّحديد وقد قام بها الباحثان الكنديّان : فيناي ودربلنت (J-P. Vinay & J. Darbelnet) في كتابهما الذي نشر بالفرنسيّة سنة 1958 (Stylistique comparée du français et de l’anglais, Didier, Paris 1958) وترجمه إلى الإنجليزيّة سنة 1995 كلّ من صجر (J.C. Sager) وهمل (J.M. Hamel) بعنوان Comparative stylistics of French and English: A Methodology for Translation, Benjamins, Amsterdam 1995. لكن ما لبثت المقاربات أن تعدّدت وعلى أنحاء مختلفة، لكن دون الخروج من مجال اللّسانيات. فظهرت أعمال نيدا (E.Nida) وجاكبسون (R.Jakobson) وكتفورد (J.Catford) ورايس (K.Reiss) وغيرهم.
4-2 : علم التّرجمة:
وبظهور السّيمياء علما قائما الذّات (شارل بيرس (Peirce)) يحدّد مجموعة من العلوم التّي تتناول العلامة في تحليلها أو تقوم عليها أداةً ووسيلة والنّقلة النّوعيّة التّي تحقّقت في المباحث والعلوم اللّغويّة بعد إرساء مبادئ اللّسانيات الآنيّة وبخاصّة البّنيويّة التّي أقيمت على الأفكار الرّئيسة لفردينان دي سوسير في كتابه التّأسيسيّ دروس في اللّسانيات العامّة ، نادى الكثير من الباحثين بضرورة استقلال التّرجمة علما قائما بذاته. ولمّا كانت اللّسانيات والعلوم اللّغويّة هي العلوم الرّائدة في التّنظير والتّقعيد .وهي التّي مكّنت التّرجمة من المقوّمات الضّروريّة (المصطلحات والأهداف والموضوع والأسس النظريّة والمجال وإجراءات البتّ الضّروريّة لتقويم تطبيق النّظريات وغيرها) التي تجعل من كلّ مبحث علما مستقلاّ بذاته، فلم يكن من الغريب أن يحاول علم التّرجمة الاستقلال عن اللّسانيات بالذّات. فقد نادى نيدا (Nida) منذ السّتّينات بعلم مستقلّ للتّرجمة في كتاب يفصح عنوانه عن محتواه: Nida (E.), Towards a Science of translation, E.J.Brill, Leiden 1964 ، كما كانت نظريّة النّحو التّوليديّ التي وضعها تشومسكي رافدا كبيرا لاضطلاع علم التّرجمة بتجاوز مسألة إمكان التّرجمة، إذ تطرح تلك النّظريّة أنّ البنية التحتيّة ، من حيث هي شكل منطقيّ كونيّ، تحمل المعنى الذي تشترك فيه كلّ لغات الكون ولا تختلف إلاّ في صيغة ترجمته التي يناسب البّنية الفوقيّة. وهكذا يقرّ النّحو الكونيّ إمكان الترجمة بين كلّ اللغات على اعتبار أنّ كلّ لغة منها ليست في الأصل سوى عمليّة ترجمة خاصّة لبنية كونيّة مشتركة. وقد توفّق الباحثون في أواخر السّتّينات إلى وضع قواعد لبذور علم مستقلّ أطلق عليه بعضهم اسم «التّرجميّة» وسمّاه آخرون «علم التّرجمة» (Traductology). ولكنّ تجاذب النّظريّات وعدم توفّر إبستيمولوجيا واضحة لهذا المبحث من شأنهما التّشكيك في إمكان استقلاله عن النّظريات التّي ترفده. أمّا العلوم الرّديفة أو الحاملة التّي تشدّ علم الترجمة إليها شدّا و من ثمّة تمنعه من الاستقلال فهي السّيمياء (نظريّة جاكبسون(Jakobson) الثّلاثيّة في المقوّمات السّيميائيّة للتّرجمة) واللّسانيات (علم التّركيب - النّظريّة التّوليديّة - علم الدّلالة - النّظريّة التّأويليّة - نظريّة نيدا في ترجمة السّياقات الثّقافيّة ونظريّة المعايير الأدبيّة والفكريّة -المصطلحيّة) وعلم النّفس ( النّظريّة العرفانيّة ونظريّة بؤرة الاهتمام )[Skopos]- وعلم الأعصاب (neuroscience of Translation) وعلم الاجتماع (نظريّة الأفضليّة والرّومنسيّة الجديدة لأنطوان برمان Antoine Berman و نظريّة الغرابة والهرمنوطيقا لهيدغار Heidegger وريكور Ricoeur ومشونيك Meshonnic والفلسفة (نظريّة دريدا Derrida التّفكيكيّة ).
4-3 : التّصنيف النّوعي للترجمات:
مع تعدّد عمليّات التّرجمة وتنوّعها واختلاف أساليبها وموضوعاتها وحواملها ظهرت الحاجة للتّمييز بينها .فبادر الباحثون إلى وضع تصنيفات مختلفة تتراوح بين التّرجمات المباشرة والجزئيّة والشّاملة والحرفيّة والمعنويّة… أو بين التّرجمات الشّفويّة (أو الفوريّة) والتّحريريّة (أو المكتوبة)؛ والعلميّة (أو التّداوليّة) والأدبيّة؛ والبشريّة والآليّة أو بين التّرجمات الأصليّة والمعكوسة (التي تعيد التّرجمة في اتجاه اللّغة الأصل) والتأّثيريّة والمشروحة والحرفيّة والتّصرّفيّة، أو بين التّرجمات الكاملة والمختزلة؛ والتّحليليّة والتّأليفيّة؛ والخطّيّة والانتقائيّة؛ والمطلقة والنّسبيّة.
4-4 : راهن التّرجمة في الوطن العربيّ :
يكاد يتّفق كلّ الباحثين على أنّ وضع التّرجمة في الوطن العربيّ متأزّم إن لم يكن متردّيا ، تسوده الفوضى ويغلب عليه تشتّتُ الجهود وغياب النّجاعة وضعف المردود. ويبدو أنّ سبب تلك الأزمة اختلال التّوازن بين الحركة العلميّة العالميّة وأعمال التّرجمة التي لا تغطّي عندنا الحاجة الاستهلاكيّة،فضلا عن الهوّة التّي تفصل بينها وبين ما تفرزه يوميّا عجلة الإنتاج العلميّ والتّقنيّ في العالم الغربيّ. و لقد أصبح من العاديّ الذي لا يقضّ مضجع أصحاب القرار أن يتجاوز معدّل المسافة الزّمنيّة التي تفصل بين الأثر العلميّ في لغته و ترجمته ما يزيد عن الثّلاثين سنة. ورغم الشّعور السّائد لدى الجميع بدور التّرجمة في التّطوّر الحضاريّ ونقل التّقانات، فإنّها لم تنل حظّها من العناية في رسم سياسات النّموّ من دعم ماديّ ومعنوي يليق بها. وتشير كثير من الإحصاءات إلى تخلّف العرب الشّديد في ميدان التّرجمة. فقد نشرت المنظّمة العربيّة للتّربية والثّقافة والعلوم (الألكسو) عدّة إحصاءات تثبت تخلّف العالم العربيّ في هذا المضمار. ويكفي أن نسوق هنا مثالا بليغا دون تقديم أيّ أرقام لإدراك الهوّة العميقة التّي تفصل مجمل البلدان العربيّة عن بقيّة أنحاء العالم. فقد بيّنت الدّراسات أنّ ما أنتجه العرب من كتب مترجمة منذ عهد العبّاسيين إلى اليوم لا يضاهي ما تنتجه أقل الدّول الغربيّة تطوّرا في سنة واحدة. فهل حالة الازدواجيّة اللّغويّة التّي تسود أغلب الأقطار العربيّة (حتّى في المرافق العموميّة) التّي كان بإمكانها أن تؤدّي دور القاطرة في عمليّة التّرجمة هي التّي تعوق تطوّرها وازدهارها؟ فإذا كان النّاس يقرأون النّصوص في لغاتها، فما الفائدة من التّرجمة ؟ ولمن نترجم ؟ قد يكون هذا التساؤل وجيها لو اقتصر قصور التّرجمة وكساد سوقها على الدّول التّي تعاني من تعدّد الألسن. لكنّ الأمر يبدو شاملا ، لا يستثني أيّ قطر من الأقطار العربيّة. لذلك يبدو أنّ الأسباب التّي تعوق تطوّر التّرجمة وازدهارها هي نفسها التّي تعوق التقدّم العلميّ. وهي غياب التّخطيط الذّي يحدّد الأولويّات في النموّ وغياب التّنسيق بين الدّول العربيّة لإرساء إستراتيجيّة موحّدة تضمّ كلّ الدّول لتحديد الحاجة وتحقيقها بأنجع الطّرق. وهو ما يعني ، بعبارة أخرى ، غياب المشروعات القوميّة المشتركة في ميدان البحث العلميّ عامّة وفي ميدان التّرجمة خاصّة. وكان من الطّبيعيّ ألاّ ينتج هذا التّشتّت للجهود إلاّ أعمالا فرديّة يغلب عليها الارتجال أو النّفعيّة الشّخصيّة. وقد نتج عن ذلك الإسراف في ترجمة الكتب والمجلاّت التّجاريّة التّي لا تنفع إلاّ للتّسلية الوقتيّة ولا تصلح رافدا لمجهودات النّهوض بالوطن العربيّ ، كما نتج عن غياب الإستراتيجيات التي من شأنها استدراك النّقص وسدّ الحاجة الملحّة إلى المراجع العلميّة من الصّنف الأوّل الإفراط في ترجمة كتب الأدب (سواء الرّاقي منه أو الرّخيص) وكتب العلوم الإنسانيّة السّهلة الرواج بنسبة تفوق أضعافا نسبة ترجمة الكتب العلميّة أو التقنية التّي تكاد تنحصر في كتب ذات منفعة عاجلة لا ترتقي إلى الهدف المرجوّ . وهو نقل التّكنولوجيات. وإذا كان من البديهيّ أنّ يزيد غياب التّنسيق بينها لتحديد الأهداف و الإستراتيجيات في تلاشي الجهود وإهدار الطّاقات، فمن الضّروريّ لتلافي هذه النقائص تخصيص ميزانيّة مشتركة تسهم في تمويلها الدّول العربيّة لتشجيع التّرجمة وتحديد سياسات موحّدة ببعث المراكز المتخصّصة والمؤسّسات التّنسيقيّة على نحو مكثّف (بمؤسّسة جامعة لها فروع في كلّ بلد من البلدان العربيّة)، وبالتّنسيق بين مختلف الأقطار العربيّة، إذ لا يكفي أن تتدارك بعض الدّول منفردة هذه الوضعيّة، كما لا يكفي وجود بعض المنظّمات التّابعة لجامعة الدّول العربيّة (الألكسو ومركز تنسيق الّتعريب بالرّباط، مثلا) لكي نتدارك التّخلّف المتراكم منذ سنين . ولا بدّ أن تسند هذه الأعمال رغبة صادقة ورؤية شموليّة للحلول الواجب الأخذ بها للنّهوض بالأمّة العربيّة وتغيير وضعها الراهن.
مقالات حديثة

عجوز و نهر
عبد القدوس أيت عبد الواحد

فول ومطر
عبد القدوس أيت عبد الواحد

الثعبان الآلي
عبد القدوس أيت عبد الواحد

الأرقام الرابحة
عبد القدوس أيت عبد الواحد
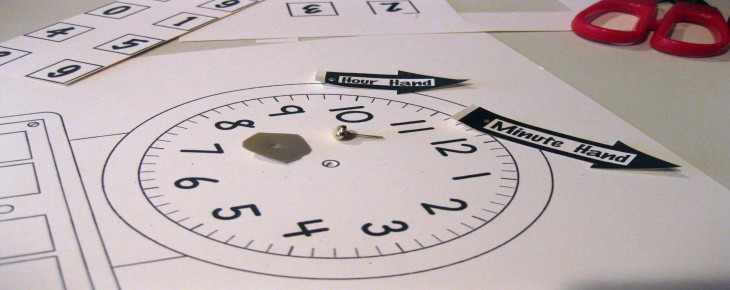
بين الزّمن والزمان والوقت
الهادي شريفي

الفرق بين جوف وباطن
Kenza Ighid

المعاجم اللغوية العربية
إبراهيم حبيبي

الرسائل اللّغويّة
محمد بوزاهير

البلاغة العربيّة
محمد بوزاهير

المكانز اللّغويّة والأرصدة اللّغويّة
محمد بوزاهير
